-
الفلسطيني في رواية "اليركون" للكاتبة صفاء أبو خضرة

الفلسطيني والمكان:
المكان بالنسبة للفلسطيني جزء من ذاته/ وجوده، لهذا لا ينفك عن تناوله وذكره أينما كان، وأن تأتي رواية حاملة اسم مكان "اليركون" نهر العوجا لهو مؤشر على أهمية المكان وقوة حضوره.
لكن أهمية المكان لا تكمن في كونه مكاناً فحسب، بل في الحياة الاجتماعية التي تجري فيه وعليه، من هنا نجد الحياة الاجتماعية وما فيها من هناء وشقاء، ومن فرح وحزن، من بطولة وجبن، من عطاء وتخاذل، من أمل وإحباط، بمعنى أن هناك خيراً وشراً، خصباً وجذباً، حياة وموتاً، هكذا نطر الفلسطيني/ السوري منذ فجر التاريخ للحياة وما زال حتى الآن، وما وجود طقوس الموت، غياب البعل الذي ما زال يقام حتى الآن: "اختفى صالح العثمان، إن النهر جرفه إلى حيث لا يدري أحد... في ذلك اليوم لطمت أمه رأسها، وبكت، وبكينا معها، كنا نقيم حلقات اللطم، في الساحة، أو في بيت الميت، نرقص مثلما يرقص ديك مذبوح، ندور حول أنفسنا، والحزن يفتت أكبادنا" ص 37، والقيام بطقوس الفرح وعودة البعل: "كانت تبقى مع الفجر تخبز على الطابون أملا منها أن يأتيها على حين غفلة، فيأكل من خبزها طازجا، ذات فجر خبزت ودخلت منزلها كي تصلي، وعندما أنهت صلاتها وخرجت أرغفة من الخبز مفقودة كانت قد لفتها في بقجة من القماش كي لا تجف من الهواء، حملت باقي أرغفتها وشيئا ما في صدرها أنبأها أن ابنها صالحاَ هو من أخذها... وبعد أن حدّثت نساء القرية بالأمر صارت عادة عندهن يستحضرن رجالهن الغائبين، منهن من كانت تضع سلة من الفاكهة التي يحبها زوجها قرب النهر لتجدها في اليوم التالي مفقودة، ومنهن من وضعت الحلوى، كل واحدة تضع ما يحب ابنها في سلة أو بقجة أو حتى قطعة قماش يتركنها عند الفجر" ص 38، فهذا الفعل ما هو إلا تأكيد لاستمرار هذا الوجود الاجتماعي، واستمرار النظرة (الطبيعية) للحياة التي فيها الموت والحياة، فيها الخريف والربيع، فيها اليم والبعل.
إذا ما توقفنا عند المشهد السابق سنجده مطابقا تماما لما فعله أجدادنا قديما عندما حزنوا على غياب البعل وفرحوا بعودته، ومن يقرأ ملحمة البعل وأسطورة دانيال سيجد هذا التماثل في الطقوس، بمعنى أن وجودنا في المكان/ فلسطين يمتد إلى آلاف السنين وما زال قائما حتى الآن، لهذا ما زلنا نمارس طقوسنا في الموت والحياة.
إذن الفلسطيني لا يتعامل مع المكان بشكله المجرد، بل من خلال كونه جزءاً من كيانه ومن ذاته، تقدم لنا الساردة هذه الصورة عن طبيعة العلاقة التي تجمع جدتها بالمكان من خلال هذا المشهد: "منذ طفولتي علقت في ذهني صورة نهر اليركون، وكنت أرى دمعة جدتي رشيدة تسقط فيه كلما حدثتني عنه، كانت تغرف منه غرفة بيديها وتغسل وجهها فيضيء، ليس غريبا أن يحن الغصن إلى جذوره، لكن أن يعود على شكل حطبة فإن هذا أسوأ ما يكون" ص 110، اللافت في هذا المشهد أن من مكونات نهر اليركون الدمع، دمع الفلسطيني، بمعنى أن فيه مكوناً إنسانياً يضاف إلى الماء.
وإذا ما توقفا عند الماء ودوره في التحول الإيجابي: "تغسل ووجهها فيضيء" نتأكد أن البعد التراثي القديم الذي بدأ باغتسال أنكيدو وتحوله من الوحشية إلى المدنية بعد الاغتسال، وتعمد المسيح الفلسطيني/ السوري بالماء ليكتمل تكوينه ودوره كمخلص للبشر، وإقدام المسلم على الاغتسال ليكون نقيا طاهرا أمام الله، إلا صور من تواصل وتفاعل وبقاء الفلسطيني المتفاعل اجتماعيا مع المكان.
ومن مشاهد هذه العلاقة تقول الساردة عن أمها وجدتها: "كنت أنظر إلى الصورة المعلقة على جدار منزلنا في المخيم، صورة لمسجد قبة الصخرة، وأسأل أمي: هل هذه الجنة...؟ فكانت تجيبني: نعم... إنها الجنة... أما جدتي مريم فعندما كانت تزحف بكل ثقلها إلى غرفتنا الصغيرة وتنظر إلى الصورة، تتأوه وتقول يا اااه... إيمتى الرجعة يا رب... إيمتى...؟ كان هذا المشهد يتكرر كل مرة... وفي كل مرة تنظر إلى الصورة ونعود إلى الشجرة ذاتها... والحلم ذاته" ص 117 وص 118، اللافت في المشهد أن الساردة تذكر المكان مقرونا بحالة الإيمان، فالمكان هو الجنة ذاتها، كما أن له قدسية ذات طابع إسلامي "مسجد قبة الصخرة" وقدسية مسيحية من خلال جعل الصورة أيقونة تتعامل معها الأم والجدة كما يتعامل المسيحي مع صورة المسيح وصورة القديسين، وبهذا تكون الساردة قد جمعت ووحّدت وأكدت اللحمة الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني الذي يتعاطى مع الصور بالطريقة ذاتها وبعين قدسية المضمون وما يحدثه من أثر في المؤمن الناظر، بصرف النظر إن كان من أتباع هذه الديانة أم تلك.
الطابون وخبز الصباح يعيدنا إلى ولادة الفجر، إلى ولادة البعل/ الخصب/ الضياء، وإلى انحسار الظلام/الموت، فعندما يأتي الصباح من المفترض أن يأتي معه الخير، لكن الفلسطيني الذي غاب عنه بعله/ المكان/ الوطن لا يرى في الفجر إلا تذكيرا بألمه، بالموت/ بالغياب الذي ما زال يختطف الحياة "كانت رشيدة تأكل من خبز الطابون الذي أعده عبود وزوجته وتشم رائحة قريتها "جريشة" فيه، تتنهد وتتذكر وتتحسر، تقف اللقمة في حلقها وتغص فيها مرارة" ص 166، هذا المشهد متعلق بالجدة "رشيدة" التي هُجرت من وطنها كرها غصبا، وما زالت تتذكر وتعيش في (ماضيها) الجميل، بمعنى أن هذا التماهي متعلق بالفلسطيني الذي عاش في فلسطين وتركها مكرها، وهذا أمر طبيعي لكل إنسان أُجبر على فعل لا يريده.
لكن كيف هو حال "لميس" التي لم تشاهد ولم تعش في فلسطين ولم تعرفها؟ تخبرنا الساردة بقولها: "ثمة طنين دائم يذكرها بأنها لاجئة، رغم حبها لمسقط رأسها وإحساسها بالولاء، لكنها تيقنت أن كل بلاد العالم لن تكون بديلا لها عن وطنها الأصلي فلسطين، مسقط رأس أجدادها، أيقنت أن الوطن يسري كالدم في عروقها وكالنايات، الحزن لحنها الدائم، لأنها تحن إلى أصلها الذي اقتطعت منه، كل ذلك كانت تقوله لكل من يسألها: كيف تحبين وطنا لم تريه أبدا!" ص 167، هذا المشهد يؤكد الروحية التي تجمع الفلسطيني بوطنه، فهناك (روح) تسري فيه كالدماء تماما، وتنقل الجينات من الآباء إلى الأبناء، بصرف النظر عن الزمن والمكان الذي يُولد فيه الفلسطيني، فالفلسطينية حالة كرامة تتماثل مع الكرامة التي خصها الله للأولياء والصالحين الذين يتوالدون وينجبون أمثالهم من الخيرين والمؤمنين.
إذا كانت هذه المشاعر تجاه وطن/ مكان لم تره أو تشاهده، فكيف سيكون اللقاء/ لقاء الوطن الذي ليس كمثله لقاء، تحدثنا لميس عن هذا اللقاء من خلال هذا المشهد: "من كان يصدق أنني سأحقق حلمي بالذهاب إلى فلسطين بتلك الصورة المؤلمة، كنت أشتم رائحة البحر من النافذة الصغيرة، وأشعر بالحب العظيم، عندما أسأل الفتيات في البرش يقلن إن البحر بحر حيفا، ياااااه حيفا إذن... أخت مدينتي يافا... يااااه يا الله هل حقا أنا في حيفا... في فلسطين... يا الله أخرجني لو لحظة واحدة أرى بلادي وبعدها أموت..." ص 177، رغم وجود "لميس" في سجن إلا أنها موجودة في وطنها، لهذا جاء المشهد بهذه المشاعر الدافئة، فهي تتجاهل/ تنسى ضيق السجن/ المكان وما فيه من أذى وحصار، ويحررها البحر الفلسطيني من السجن لتكون في مكان آخر، في وطنها يافا.
نلاحظ أن النقلة من الموت/ الضيق إلى الحياة، إلى الآفاق، جاءت بأثر المكان الواسع البحر وحيفا، فبدا السجن رغم ما فيه من ألم وقهر (مكانا صغيرا، تافها) تجاهلته "لميس" بعد أن وصلتها رائحة البحر، بحر فلسطيني، وبما أنها أنثى والبحر ذكر، فقد جاءت مشاعرها صدقة وطبيعية، وحديثها حميم تجاه من أحبت وتحب، البحر ويافا.
الصهاينة:
من مهام الأدب الفلسطيني كشف/ توثيق حقيقة ما جرى ويجري في فلسطين، وكيف تم تشريد شعبها، والطريقة التي عامله بها المحتل، من هنا نجد الساردة تبين لنا في أكثر من مشهد الوحشية التي استخدمها المحتل ضد الفلسطينيين: "في العاشر من آذار عام 1948 م، وضعت مجموعة من أحد عشر فردا، تحوي قادة صهاينة وضباطا عسكريين، خطة لتطهير فلسطين عرقيا بشتى الوسائل، والاستعداد لطرد منهجي ومنظم ومدروس، وكانت أبرز الوسائل المتبعة بالقوة وإثارة الرعب ومحاصرة القرى وقصفها، وحرق المنازل والأملاك والبضائع" ص 44، هذا المشهد يختزل ما جرى في النكبة عام 1948، ويذكر/ يعرف المتلقي بالطرق التي تبعها الصهاينة لتفريغ فلسطين من أهلها، وبما أنه جاء من خلال نص أدبي روائي، وهذا يسهل ويرسخ المعلومة أكثر في القارئ.
تحدثنا الجدة رشيدة عما رأته بنفسها في النكبة: "ولا تزال تذكر تلك اللحظة التي رأت فيها الجنود يجمعون كل شباب الحي ويديرون رؤوسهم إلى الحائط، ويتأهبون ببنادقهم ويصوبون عليهم مباشرة في الرأس، ذكرت أنهم لم يتوقفوا عن إطلاق النار حتى بعد أن سقط الشباب أرضا ودمهم يسفح الأرض" ص 445، رغم أن المشهد يبدو سينمائيا، إلا أنه حقيقي، وما يفعله الاحتلال الآن في غزة يؤكد وحشية وبربرية المحتل الذي لا يتوانى عن قتل وتعذيب وتشريد وطرد الفلسطينيين.
وتقدم مريم شهادتها عن تلك الأحداث بقولها: "بعد انسحاب القوات البريطانية قامت العصابات الصهيونية بقصف يافا بقذائف الهاون والمورتر، وقد روج الإعلام آنذاك لفظائع أفراد العصابات الصهيونية المسلحة، من خلال اجتياحهم قرية دير ياسين، من شق بطون الحوامل، وذبح الأطفال، والاعتداء على الأعراض أثناء انشغال البشر بتشييع جنازة عبد القادر الحسيني" ص 56 وص 57، الحديث عن المجازر الصهيونية من أكثر من شخصية في الرواية، يشير إلى حجم الوحشية التي استخدمها الصهاينة واستمرار أثر تلك الجرائم على الفلسطيني رغم مرور عقود عليها، فالرواية تريد إيصال وتوثيق الأحداث حتى لا تغيب، وتبقى عالقة في ذهن القارئ، لعل وعسى يكون من هناك من يثأر للفلسطيني ويحقق له العادلة.
ولم تقتصر الجرائم الصهيونية بحق الناس فقط، بل طالت الكتاب والآداب التي أنتجها الفلسطيني: "سرقة قطع نادرة من كتب الشعر، ونسخة من القرآن الكريم كتبت بخط اليد ومزخرفة بالذهب، وأن أستاذا في الجامعة العبرية أخبره ذلك، وأن هذا الأستاذ يعرف النشاشيبي وأسرته، ولديه الكثير من كتبه المنهوبة" ص 146، إذن هناك نهب/ احتلال لكل ما هو فلسطيني، فالاحتلال لم يقتصر على احتلال الأرض وطرد السكان، بل امتد ليصل إلى الإنتاج الأدبي والفني والمعرفي والعلمي والتراثي.
وهناك سرقة للحياة النباتية الفلسطينية وتهويدها: "كما حاولوا تهويد زهرة السوسن "الملكية" التي تنتشر في قرى فقوعة وجلبون في محافظة جنين بالضفة الغربية تحيدا" ص 173، وهذا يؤكد أن الكيان الصهيوني قائم على سرقة ما هو فلسطيني، وانتحال ما ليس له، فالصهاينة مفلسون ثقافيا وتراثيا وتاريخيا، لهذا تجدهم يسرقون كل ما هو فلسطيني أو يحاولون إزالته.
بهذا تكون الرواية قد وضعت القارئ أمام حقيقة ما جري ويجري فلسطينيا، وعليه أن يتخذ موقفا واضحا، فلم يعد هناك لبس أو شك بوجود جرائم تتمثل بسلب الأرض وقتل وتشريد من عليها، وانتحال وسرقة ما خلفه الفلسطيني ليمسي (إسرائيليا).
الفلسطيني:
إذا ما وقفنا عند نتائج تهجير وتشرد الفلسطيني سنجدها نتائج مدهشة، فقد تم تشريد شعب من وطنه وحرمانه من ثروته المادية وإرثه الثقافي والحضاري والاجتماعي، وأخد التشرد تغيرا اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا ما زال أثره قائما حتى الآن، من مظاهر التهجير والتشرد: "في المخيم يكبر البشر على عجل، ستجد طفلا يعيل أسرته في العاشرة من عمره، لأن أباه مات، أو هاجر إلى حيث لا يدري أحد، أو فر من جحيم المخيم وجحيم الانتظار إلى الحرب. كانت لبنان كمن تفتح شدقيها للبشر، يذهبون ولا يعودون إلا جثثا، أو لا يعودوا أبدا، ثم كانت الاجتياح" ص 21، في هذا المشهد تختزل الساردة جزءا مما جرى للفلسطيني، فهناك مخيم، في أطفال كبار، في جوع وفقر، فيه حياة غير سوية/ عادية، وفي مقاومة وحلم بالعودة، بمعنى أنه مكان طارد لساكنيه ومن هم فيه، منهم من يتركه لأسباب حياته: "أيامذاك صرت أدرك أن حلمي أعلى من صفائح الزينكو التي تعلو سقف المنزل، حلمت بسقف غير مثقوب تتسرب منه المياه كل شتاء، ما كان يحرمني من النوم" ص 23، ومنهم من يتركه ليستعيد وطنه من هنا تم ذكر لبنان الذي أكل العديد من الفلسطينيين؛ إما بسبب الحرب الأهلية، أو بسبب الاستشهاد أثناء مواجهة الاحتلال.
وأما عن الهجرة وأثرها على الفلسطيني، فتقول الجدة "رشيدة": "والله يا ستي كلبي بوجعني، أحنا مثل سمك الكراميط لما يطلع من المي بموت، لما طلعنا من فلسطين متنا، والله متنا يا ستي" ص 41، اللافت في هذا الكلام أنه جاء بلهجة فلسطينية محكية، وهذا يشير إلى استمرار (الفلسطينية) وحضورها في الفلسطيني رغم عقود من الهجرة، كما أن مضمون/ معنى الكلام يحمل مأساة الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يعيش إلا في فلسطين، فهو كالسمكة التي إذا ما خرجت من وطنها/ البحر ماتت، أما "أم قاسم" فنجد فلسطينيتها من خلال قولها: "هلكيت إنعدل راسي المايل، ولم أكن بالطبع سأبدل رائحة البرتقال والحمضيات المنبعثة من البيارات بتلك الرائحة، كنت أقطف في الفجر بضع ورقات من شجرة الليمون، وأضعها في إبريق الشاي، ونشرب بلذة مع صوت الآذان، حيث رائحة الياسمين في حوش الدار، والريحان، مع أولى النسمات تعطر صباحاتنا، يا اااااه... ما أحلى بلادنا" ص 70 وص 71، هذه الصورة أيضا نجد فيها المرأة الفلسطينية من خلال التمسك باللهجة المحكية، ومن خلال الحنين للبيت الذي هُجرت منه وتركته خلفها.
غسان كنفاني:
غسان كنفاني حاضر في العيد من الأعمال الأدبية الفلسطينية والعربية، إما مباشرة كما هو الحال في اليركون، وإما من خلال التناص والإشارة إلى أعماله الرواية "لماذا لم تدقوا الخزان". اللافت في راوية اليركون أنها تذكر غسان في أكثر من موضع وحتى أنه تشير إلى حركة القوميين العرب، وبما أن هناك شخصية روائية تحمل اسم "غسان" وهذا يجعلنا نستنجد أن هناك بعدا (أيديولوجيا) ومعرفيا تحمله الرواية.
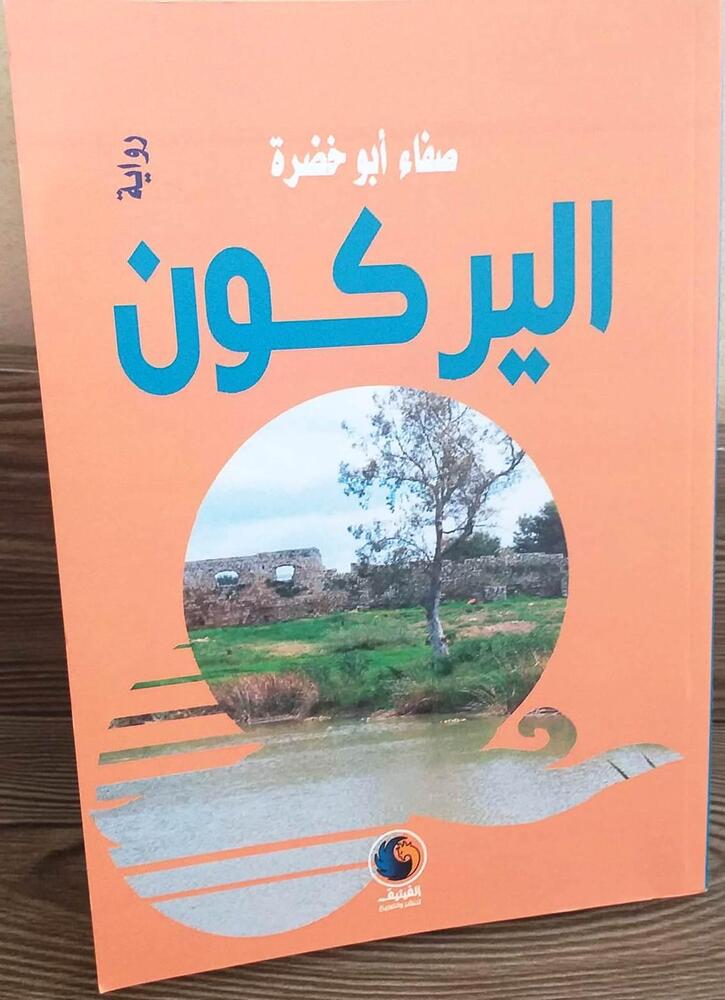
من أشكال حضور غسان كنفاني ما كتبه غسان للميس: "قرأت مرة مقولة لغسان كنفاني: "لن تستطيعي أن تجدي الشمس في غرفة مغلقة" ص 50، هنا نجد حضور غسان مباشرة، ومن خلال ما كتبه، وما الاقتباس لكلامه إلا من باب حث القارئ على التقدم من أعمال غسان وما فيها من ثروة أدبية ومعرفية وأخلاقية، وتم ذكره مرة أخرى والحديث عن استشهاده: "تذكرت غسان كنفاني الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي بتفجير سيارته مع ابنة شقيقته" ص 179، رغم (المباشرة) في تناول "غسان" إلا أنه جاء ضمن حالة/ حدث روائي يخدم فكرة وحشية الاحتلال الذي لا يتوانى عن قتل وسفك دماء الفلسطيني أينما كان وحيثما حل.
الكتب والأدباء:
عندما تناولت الرواية "غسان كنفاني" أرادت إيصال فكرة أهمية المعرفة ودورها في مواجهة الاحتلال، من هنا نجدها تكمل هذا الأمر من خلال ذكر أدباء وكتب، وكأنها تدعو القارئ لينهل من تلك المعارف والتعرف على أولئك الأعلام وتلك الكتب، يحدّث "زياد" عن مكانة المكتبة لديه بقوله: "مكتبتك الضخمة التي ورثتها عن والدك والتي كان يجمع كتبها من كل معارض العالم... ماذا سيفعلون بها من بعدك" ص 30، هذا المشهد تكرر في غير رواية، ففي رواية "بيروت بيروت" رشاد أبو شاور تم ذكر المكتبات التي تركها خلفه في كل هجرة، هجرة 67، وهجرة القاهرة، وهجرة بيروت، وهذا يؤكد أهمية الكتاب بالنسبة للفلسطيني، الذي يمثل أحد مظاهر وجوده، وإحدى وسائل مقاومته: "كانت كذبتك الأولى أنك ستنسى وتواصل الكتابة حتى آخر نفس، ها هو النفس بدأ بالتخلي عنك ولم تكتب بعد" ص 32، بهذا الشكل استطاعت الساردة حثّ المتلقي على القراءة، وتحفيزه على اقتناء الكتاب لما فيها من عوالم معرفية وأدبية وأخلاقية تدعو إلى الحرية والتحرر والتمسك بالعدالة وبالحق رغم قسوة الواقع وبلادة الأفراد.
شخصيات الرواية:
إذا ما توقفنا عند شخصيات الرواية سنجدها متباينة، منها الشاب ومنها الشيخ، منها الرجل ومنها المرأة، منها الإيجابي ومنها السلبي، وهذا يمثل صورة (واقعية) عن طبيعة المجتمع، وإذا ما توقفنا عند عدد الشخصيات الإيجابية وعدد الشخصيات السلبية، ودورها في الرواية، سنجد أن الغلبة للإيجابية، إن كان على صعيد الكم والنوعية وطبيعة الدور الذي تقوم به، وهذا يعكس فكرة الأمل الذي تحمله الرواية، فالأفكار التحررية التي جاءت بها، تفرض وجود ما يجذب المتلقي إليها، من هنا كان لا بد من استخدام محفزات تقدمه من الفعل، لهذا كانت إيجابية الشخصيات هي السائدة والغالبة في الرواية.
السرد الروائي:
نلاحظ أن السرد الروائي جاء بثلاثة صيغ، تداعي ضمير المخاطب، السرد الخارجي، أنا السارد، وقد تم توزيع هذا السرد بطريقة منتظمة في الثلث الأول من الرواية، لكن بعدها أخذت أشكال السرد (تختلط/ تتشابك) فيما بينها، وهذا الأمر يستوقف القارئ ويتساءل: لماذا تم التخلي عن انتظام نسق السرد؟ وهل له علاقة بمضمون الرواية وأحداثها؟
أعتقد أن الخروج عن نظام السرد له علاقة بمضمون الرواية، فبعد أن تعددت الأحداث وتفرقت الشخصيات، ودخلت "أم هيثم وأم نادر وناجي" وما أحدثوه من خلل في المجتمع، كان لا بد أن تظهر هذه السلبية في الرواية، فكان (الخلل) في نسق السرد إحدى أشكال تلك السلبيات التي انعكست على شخصيات الرواية وعلى انتظام سردها، فكان شكل وطريقة السرد يمثل صورة عن تلك التحولات التي جاءت في الرواية وشخصياتها.
تداعي ضمير المخاطب:
وهنا نتوقف عند شكل السرد وعلاقة بطبيعة الشخصيات، كلنا يعلم أنه عندما يكلم الإنسان نفسه فهذا يشير إلى حالة الضغط النفسي الذي يمر به، ويشير إلى حالة (الجنون) التي وصل إليها، وإذا ما تتبعنا سرد تداعي ضمير المخاطب سنجد هذا الضغط وهذا الجنون والخروج عما هو مألوف حاضرا ومؤثرا وفاعلا: "وتتدخل في كل تفاصيل حياتك، أصبحت محني الكتفين، ذابل الوجه، ممتقع الملامح/ أقرب إلى الجنون منك إلى العاقل".
هل المجنون هو من يحدث نفسه في الشارع؟ أم هو ذلك الذي لا تحزر تصرفاته؟ أم كلاهما معا؟" ص 14 وص 15، نلاحظ حالة الضعف/ الضيق/عدم الاتزان/ تلازم السارد الذي ضاقت به السبل، فأمسى تائها/ ضائعا/ مغتربا، وهذا ما يجعل شكل السرد أحد وسائل إيصال الفكرة عن طبيعة الشخصية التي تقدمها الرواية.
يحدثنا الروائي السارد عن مظاهر جنونه وخروجه عما هو مألوف: "انتظرت حتى يهدأ الثور الذي سكنك فجأة، بينما يرى كل شيء أمامه يكتسي باللون الأحمر، ولن يهدأ إلا بكأس من الدم.
نطحت مرآة قريبة مزركشة جوانبها بالأحمر، ولم تهدأ إلا حين رأيت الدماء وهي تنفر من رأسك، أفقت بعدها على نفسك بقطب متعددة في رأسك، ويد ملفوفة بشاش أبيض" ص 34، إذن شكل السرد يوضح طبيعية الشخصية المتحدثة، ويوضح حالة الضغط/ الجنون التي يمر بها، وهذا ما جعل القارئ يتعرف أكثر على طبيعية الشخصيات ويدخل إلى نفسيتها وما تحمله من معاناة.
كتابة الرواية والشخصيات:
رغم إيجابية وتقدمية المضمون الذي تحمله الرواية، إلا أن ذلك لا يكفي لتكون الرواية متميزة، فكان لا بد من وجود شكل أدبي يوازي جودة المضمون والأفكار، فكان الخروج على وتيرة السرد وتدخل الساردة التي (غربت) الرواية وجعلتها مثيرة للقارئ، من أشكال هذا التغريب: "النص الذي أبهرك أعدت قراءته مرارا وتكرارا وكان النص الوحيد المخالف لشروط المسابقة، لم يحمل أي عنوان ولا اسم، فقط الفصل الأول" ص 15، العلاقة بين الأحداث والشخصيات من جهة وبين تداخل الساردة في السرد يمثل (ثورة/ تمرد/ جنون) على الواقع، كما أنه في الوقت ذاته يبين ويوضح (أزمة) الشخصية التي تتحدث بتداعي ضمير المخاطب.
وعن علاقة الروائي بالقارئ وبما يقدمه في الرواية يقول الروائي: "نفرغ ذاتنا حين نفهم في لحظة عابرة أن ما نقوله كذب،... إننا لا نشبه كلماتنا، وإن الكلمات مجرد ثياب نلبسها لنغطي عورتنا، نخدع بها الكائنات... تجنح في الخيال، تدغدغ عواطف البشر، ثم فجأة تكتشف أنك كنت طوال عمرك تخدع نفسك وتخدعهم" ص 31، بهذه الفقرة أراد الروائي الإشارة إلى أدبية الرواية وليس إلى (واقعيّتها) رغم أنها تتناول أحدثاً (حقيقية)، وكأنه بهذا (اللخبطة) يريد منا التوقف عند الشكل الذي قدمت به الرواية وعلاقته بحالة (الجنون/ التمرد) التي يمر بها الروائي.
ويشير الروائي إلى العلاقة بين (تغريب السرد) الروائي وبين الأفكار التي طرحها بقوله: "وكنت مثل الوحش الذي تهرب منه كل الكائنات... حتى كائنات روايتي يفرون مني وأبقى على ملاحقة دائمة خلفهم" ص 157، وبهذا يكون (الروائي) قد أوصل فكرة اغترابه/ جنونه/ تمرده على الواقع، إن كان من خلال الأحداث والمضمون، أم من خلال أشكال السرد، أم من خلال الطريقة التي قدمت بها الرواية، وما التماهي والتوقف طويلا عند تفاصيل العرس الذي تناولته "لميس" بعد مشاهد التحقيق والتعذيب التي تعرضت لها، إلا صورة من الصور التي تعكس ما يحمله العقل الباطن للساردة، فحجم المعاناة والقسوة والعذاب الذي مرت به أثناء التحقيق جعلها (تغرق) في تفاصيل فرح، لعل وعسى يخرجها/ي خلصها من الألم الذي أصابها وما زال عالقا بها.
* الرواية من منشورات دار الفينيق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2024.
بقلم: رائد الحواري
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!























