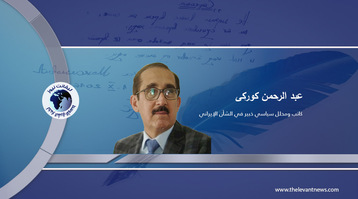-
الجملكيات "التبريرية" والنقد المعارض!

ما أسهل ممارسة القول التهكمي التكفيري، خاصة إذا ما كان يعتمد مركزية قدسية مرجعيتها النفي الكلي للطرف الآخر، وعدم الاعتراف بحقه ووجوده رأياً وممارسة، متزاوجاً مع الإقرار الحتمي بامتلاك الحقيقة المطلقة، وأحقية التوجيه خلاف غيره!
منهجية الإذابة الكلية للواقع بكل تجلياته في جمل من الكلمات، وفلترتها في نموذج وصفي وتبريري واحد، وبوتقة واحدة من ألوان الحكم التهكمي والقيمي، هي العازفة نشازاً وتعميماً في حواراتنا لليوم، وللأسف "نحن" دعاة الحرية والتحرر، وهذه النحن الجوفاء، النحن القبيلة، النحن العصبوية، طاردة الأنا المتفردة والمختلفة من اتساقها، شر البلاء وأساس النفور والتشظي! فما يبدو في ظاهره نقداً، لكن في باطنه التهكم وازدراء الآخر وإقامة نظام خليط بين شكلانية الديموقراطية السطحية وبين ملكية إطلاقية للحقيقة، كانت قد سماها واسيني الأعرج سياسياً "جملكية" تزاوج بين نظام حكم جمهوري شكلي، وملكي مطلق توريثي بالعمق!
هذا، بينما النقد كمنهج يبحث بين حدي المتعة المعرفية ومحاولة التغيير الواقعي، حسب هيغل، يبدأ بالتحديد والتفريق بين الإثبات/الإيجاب والنافي/ السالب! وبالضرورة التعيين والتحديد والبحث عن البديل. فبين المعرفة والتغيير من جهة وبين إطلاق الصفات الكلية رفضاً أو قبولاً، تبدأ مفارقة معرفية عنوانها الأبرز: بين النقد والتهكم!
تكاد لا تخلو ساحة من ساحات المعارضة السورية طوال السنوات التسع الماضية، من ممارسات تُسمى نقدية، لكنها شكل من البزار اللامنتهي لليوم في إثبات أحقية وجهة نظر وسلوك خلاف غيره، وصلت في مواقع عدة لاستخدام اليد والتطاول والتخوين وإقامة القطيعة الكلية بين بعض أطرافها! فإن كان مبرر هذا الشحن العاطفي والمتوتر والمترافق مع سياقات الثورة وممراتها المفصلية وحجم وكوارثها، حيث تثير كلمة الثورة والثوري لمجموعة من المشاعر السلبية والإيجابية المشحونة عاطفياً، لما لها من صور شبه متقاربة في المخيال الجمعي من الهيجان والعنف! لكن هذه التبريرية بذاتها يمكن أن تجد معززات حضورها النفسي حين يكون الحدث فاجعة تمس الشخص بذاته كما الانتماء في الوجود، فلا يمكن أن تلوم شخصاً بشدة هيجانه وغضبه حين يحرم من أبناءه او أسرته أمام عينيه بمعتقل أو ببراميل وصواريخ طائرة او بغرق في بحر هجرة!
أما أن تصبح التبريرية قاعدة وسلوك عام يمارسه أنداد السياسة، فهذا لا يعني سوى أن هذه السياسة لليوم، لم تتشكل في حلقاتها المعرفية بقدر انغماسها في صراع بيني على أحقية القرار سلطةً والقيادة ثورياً، حيث الأيديولوجية واحدية اللون، وخلافه العدم، في مشابهة فاقعة تاريخية لذات النموذج "البلشفي" التاريخي الذي أتى على أرضية الثورة الماركسية، حين تحولت السلطة وشكل الاستحواذ عليها وممارستها أداة للهيمنة والسطوة على الجمهور بلون واحد ألغى الديموقراطية والحريات التي كانت السبب الذي قامت لأجله الثورة ضد حكم القيصر!
في قراءة نقدية قام بها الدكتور برهان غليون لسلوك المعارضة السورية، وصفها بالطفولية وضرورة تجاوزها، يبرز فيها النقد الكثيف لعدم تمكن المعارضة السياسية الثورية تشكيل مركز قرار وطني، يفتقد لاستراتيجية عامة تتعامل مع الحدث السوري بكل تقلباته ومنعطفاته. مشيراً إلى دور الإسلام السياسي في ابتلاع الثورة من جهة، وبقاء ممارسة شتى صنوف المعارضة السورية التنابذي متمسكة بأيديولوجياتها الحزبية ذاتها، دون العمل على البعد الوطني خارجها. من جهة أخرى، فإن كلام د. غليون يبرز من خلفه الحرص على المسار الوطني، لكنه يحتاج للتدقيق في مفاصل وتعرجات الثورة وهذا حق سياسي عام للجميع. لكن الملفت للنظر أن معظم صنوف المعارضة تتناول هذا النقد بذات الطريقة التي أشار إليها، بحيث تحمّل كل جهة منها مسؤولية الطرف الآخر في ذلك، في محاولة تبريرة لتخليص مسؤوليتها الوطنية منها! فمنها من يحمّل الإسلام السياسي جلّ المسألة، ومنها من يحمّل القوى الديموقراطية ذلك، ومنها من يحمّل باقي الأطراف المسؤولية ويتنصل لنفسه خارج خريطة المأساة العامة، وهنا هي المأساة والكارثة!
في قراءة نقدية مقابلة، أشار علي العبدالله، أحد قيادي "إعلان دمشق"، لهامشية وهشاشة دور القوى الديموقراطية ذات النزعة العقلانية المتأثرة بفكر إلياس مرقص وياسين الحافظ وجمال الأتاسي في السياسية لدورها السلبي في الثورة، ناسياً ومتناسياً قدرة هذه القوى على إيجاد نقاط التوافق العام وعملها المتسع فيه، حين شكلت مساحة واسعة للرأي والرأي الآخر أثناء تشكيل إعلان دمشق ذاته عام 2005 والذي اعتُبر في حينها خطوة متقدمة سياسياً على مستوى الإجماع الوطني لكل صنوف المعارضة السورية. قوى العقلانية السياسية هذه، ولنقل الأفراد ومنها د. غليون، التي عملت بلا أيديولوجيات الاستحواذ على قرارٍ سياسي لفريق دون غيره، سوى القرار الوطني وأحقية ابرازه في معركة الاستبداد، مثلت نقاط التوافق والإجماع الوطني خارج عن التشدد الحزبي والأيديولوجي الذي مارسه، ولازال يمارسه، بعض أحزاب المعارضة السورية خاصة ذات المرجعية الماركسية اللينينية ذاتها على اختلافها السياسي وتعدد منابرها، فكان يومها مشروع التغيير الوطني التدريجي السلمي. وأتساءل اليوم معه: ماذا بقي من التوافق الوطني هذا، أمام تسارع الحدث السوري، ومحاولة كل فريق في كتلة إعلان دمشق التنصل من مسؤولياتها التاريخية فيه، وتحميله للطرف الآخر؟ والسهل على الجميع تحميل الإسلام السياسي كامل المسؤولية؟
السؤال الأبرز اليوم، هل يمكن لصنوف المعارضة السورية التشارك في المسألة الوطنية مرة أخرى، بعيداً عن التبريرية و"جملكية" الحقيقة الوصفية؟ وبالضرورة، هل لها أن تعيد توافقها حول المشروع الوطني بعد أن ذررته وشتته بتنابذها وتنافرها غير المنتهي؟ وهل يمكن التوافق على بعض محددات ومحطات ترسمت في مسار الثورة السورية في سنواتها التسع الماضية، دون تخفيض للنقد لمستويات التهكم الطرفي:
- سلمية الثورة تحققت بكل معاييرها سورياً وعدم نجاحها بالتغيير السياسي لا يعني أبداً فشلها، والعسكرة كانت قد فُرضت على الناس إجبارياً ما أفقد الثورة سلميتها ومدنيتها.
- العسكرة والعنف أظهرتا مستوى عمق الشروخ الأفقية والعامودية في البنية المجتمعية، من حيث إذكاء العنف الطائفي، واستدعاء النزعة الغريزية في القتل المجاني.
- "الأسلمة" و"العلمنة" مجرد مقولتان وظيفيتان في معادلات الحرب السورية، تم استثمارها لأغراض جيوسياسية دولية لتقاسم النفوذ الدولي عبر الكعكة السورية. وما مقولة التطرف والإرهاب سوى مقولة وظيفية دولية لتفريغ النزاع المستتر بين الروسوتينية الصاعدة والأمريكية المهيمنة على النظام العالمي وحيد القطب.
- الأيديولوجيات المعارضة السورية السياسية، أيديولوجيات كلاسيكية تباينت بين السلمية والعسكرة، ودخلت برضاها في المعادلات الدولية، فإن كانت تمثل معارضة تاريخية لسلطة النظام، لكنها دخلت الثورة من بوابة النزاع على وهم القيادة الثورية فيما بينها والوصول للسلطة سياساً بديلاً عن النظام، فهل تمتلك القدرة على مواجه تحديات المرحلة والتوافق مجدداً على آليات مرحلية لاستعادة القرار الوطني من بين فكي التغول الدولي والهيمنة الإسلامية؟
سؤال برسم القوى الفاعلة في معادلة التغيير الوطني، لا يكفيها أبدا التبريرية وادعاء ملكية الحقيقة "جملكياً"، بقدر الانفتاح على النقد الموضوعي والمعرفي، فإن كان النقد حق المختلفين رأياً، فهو لازمة توافق واشتراك في الحد الأدنى مسؤولية، والذهاب طوعاً عن فكرة السلطة كعمل سياسي وحسب، بقدر أنها ممارسة المعرفة والتداول النقدي بعين موضوعية ترسم المشاريع والاستراتيجيات لإعادة قراءة المرحلة الحالية دولياً، والبحث في إمكانيات حلولها، وإلا باتت وبتنا كلنا خارج التاريخ.
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
من وحي الساحات في سوريا
- December 19, 2024

من وحي الساحات في سوريا
ليفانت-خاص
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!